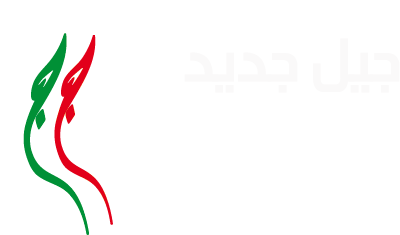التأمل الأول: العالم والفوضى
بقلم : سفيان جيلالي
“المشكلة المطروحة بشكل صحيح هي نصف الحل.” – هنري برجسون
في المفهوم العادي، تشير كلمة “الفوضى” إلى حالة من الاضطراب التام. غالبًا ما تكون غياب المعنى وفقدان الهدف الجماعي هما الأساس في تفاقم التناقضات، مما يفتح الباب للأزمات. في النظام الجيوسياسي العالمي الحالي، تعبر الفوضى عن انعدام الأمن، والدمار، وعدم القدرة على التنبؤ؛ حيث يؤدي انهيار القواعد القائمة إلى مواجهة المجهول.
ومع ذلك، فلسفيًا، ترمز الفوضى أيضًا إلى فضاء إبداعي، بداية حيث كل شيء ممكن قبل تشكيل نظام جديد.
في الواقع، تعني كلمة “فوضى” في اللغة الإغريقية القديمة “خاوس” التي تعني “الفراغ الواسع” أو “الهاوية”. في الأساطير الإغريقية، كان يُنظر إلى الفوضى ككيان بدائي، يُعتبر أصل الكون. يمثل حالة غير محددة، بلا نظام ولا شكل، كانت موجودة قبل خلق الكون المنظم. تصفها العلوم الحديثة بمفهوم “البلازما الأولية” خلال المراحل الأولى من الانفجار العظيم.
في النظام الجيوسياسي، تثير الفوضى صورة ساحة المعركة، حيث تنطلق موجات العنف، مما يعكس شياطين الإنسان التي قد تقود إلى أسوأ الانحرافات.
في تساؤل حول الطبيعة الجوهرية للإنسان، ألم يعرب الملائكة عن استفسارهم أمام الخالق؟ «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء…؟» – القرآن، سورة البقرة، الآية 30.
في كتابه الملحمي “الحرب والسلام”، اعتبر تولستوي الحرب قوة فوضوية وغير إنسانية. فقد أظهر عبثية وقسوة الصراعات، حيث بدت قرارات القادة تافهة أمام المصير الجماعي.
انتقد تولستوي أوهام العظمة لدى الحكام، الذين صورهم كغير مؤثرين في مجرى الأحداث. وتساءل عن حرية الفرد في مواجهة الحتمية التاريخية، حيث يتأرجح أبطاله بين البحث عن المعنى والخضوع لقوى غير مفهومة.
لماذا تستمر الحروب منذ عصور الإنسانية البدائية؟ لماذا تُستبدل مشاعر المودة والتضامن بين البشر برغبات الهيمنة والنهب والاستغلال؟؟
لماذا الحروب المتواصلة التي تُخاض باسم الحضارة والقيم؟
اليوم، النظام العالمي، الذي بُني بصبر عبر قرون وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، دخل مرحلة الانهيار والاضطراب (أي اللا نظام!). إذا كان القرن العشرون مروعًا، فقد أظهر القرن الحادي والعشرون بالفعل أنه يمكن أن يكون أسوأ.
لماذا هذه الصراعات الدامية في أوكرانيا، روسيا، الكونغو، السودان، اليمن، العراق، لبنان، سوريا وأماكن أخرى؟
لماذا إبادة غزة؟ لماذا هذه المعاناة التي لا توصف للضحايا الأبرياء باسم أيديولوجية تتبنى تفوق شعب يُفترض أنه مختار من الله؟ هل يمكن أن يكون الله، خالق العالم، يميل إلى تفضيل بعض مخلوقاته على الأخرى؟ أن يمنح “الأرض الموعودة” للبعض ويجعل الآخرين يعيشون جحيمًا أرضيًا؟
هل الله في حكمته اللانهائية وقدرته الكلية يدعو إلى الفوضى والاضطراب، أم أن مخلوقاته، في ممارسة الحرية التي منحها لهم، يسمحون لشياطينهم وأهوائهم بالسيطرة؟
الرسالة الإلهية التي كُشفت للبشرية تحولت تدريجيًا إلى أديان صنعها الإنسان. منذ أقدم العصور، أحب الإنسان القوة والسيطرة وامتلاك الآخرين وممتلكاتهم. وبالتالي، بنى أنظمة حكم، ثم دولًا، ثم إمبراطوريات.
امتدت هذه الإمبراطوريات، موسّعة نفوذها لتستنزف الضعفاء، سواء من مواردهم أو حتى أرواحهم.
في مواجهة بعضهم البعض، تشكلت المجموعات البشرية أولًا كعائلات، ثم كقبائل، وأخيرًا كأمم، لتنشئ بنى دفاعية ضد التهديدات الخارجية.
نظموا أمنهم الداخلي، وأقاموا نظامًا اجتماعيًا وقوانين لمعاقبة من يخالفها.
مع مرور الزمن، تعززت هذه السلطات. وفي صراعات مستمرة، كانت القوى الكبرى تلتهم بعضها البعض، حتى تصل إلى كتلة حرجة للسيطرة على الأراضي وامتلاكها.
هكذا ظهرت الدول. ومع توسع نطاقها، استوعبت أراضي جديدة وشعوبًا أخرى، لتتحول إلى إمبراطوريات. منذ بداية الحقبة التاريخية، بين 5000 و3000 سنة قبل الميلاد، تأسست أولى الإمبراطوريات، مما أطلق ديناميكية الحضارات.
انطلقت ‘لعبة الكبار’، لتتطور عبر الزمن وتزداد تعقيدًا ودموية.
سفيان جيلالي