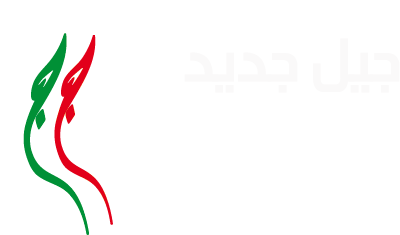التأمل الثالث: الحروب والسلام في المغرب الكبير
بقلم سفيان جيلالي
“المشكلة المطروحة بشكل صحيح هي نصف الحل.” – هنري برجسون
شعوب المغرب الكبير مثل الأشقاء. قريبون جدًا من الناحية الجينية والإثنية، ينحدرون من نفس الأصول ولكن بشخصيات مختلفة. لا شك أنه منذ آلاف السنين، استقرت شعوب في هذه المنطقة من العالم. فقد سكنت المنطقة شعوب الإيبيرو-موريزيين، الكابسيين، البربر القدماء، ثم البربر.
تعتبر شمال إفريقيا منطقة واسعة محاطة بحدود طبيعية: البحر الأبيض المتوسط شمالًا، والمحيط الأطلسي غربًا، والمناطق الصحراوية جنوبًا وشرقًا. هذا الموقع الجغرافي أتاح لها الوقت الكافي لتطوير ثقافتها الأصلية، ولغتها البدائية، وأنثروبولوجيتها المتأقلمة بالضرورة مع البيئة الجغرافية والمناخية المحلية. أدى أسلمتها وتعريبها فيما بعد إلى خلق تجانس روحي وثقافي عميق.
منذ عدة قرون قبل الميلاد، بدأت المنطقة في التبلور حول ثلاثة مراكز قوى على الأقل، والتي تتوافق إلى حد كبير مع الدول الثلاث الرئيسية اليوم. وكإخوة يشعرون بالغيرة من بعضهم البعض، حافظت هذه الشعوب على منافسة مستمرة فيما بينها عبر القرون. منذ الحقبة القرطاجية وحتى أواخر الإمبراطورية الرومانية، تميزت العلاقات بينها بالحروب الداخلية، التحالفات المزيفة والخيانة.
في القرن التاسع عشر، فرضت الإمبراطورية الاستعمارية اللغة والثقافة الفرنسية، مما حفّز رد فعل يتمثل في مشاعر الهوية القومية من خلال صعود القومية. وأصبح مفهوم الدولة-الأمة، كصيغة حديثة لإدارة المجتمعات الأوروبية، مثاليًا لكل من الشعوب الثلاثة، أو على الأقل للنخب السياسية التي كانت في طور التكوين.
لقد شكّلت الثورة الجزائرية للاستقلال انقطاعًا نفسيًا وتغيرًا ذهنيا عميقًا. لاستعادة سيادتها، كان على الشعب الجزائري أن يتبع نخبه الثورية ويشرع في تحول اجتماعي ينقله من عصر القبلية إلى عصر الدولة الوطنية. كان ذلك عملية بطيئة ومؤلمة مليئة بالصعوبات، لكنها الآن في طريقها إلى التحقق.
على الرغم من أن تونس لم تشهد ثورة، إلا أنها وجدت نفسها على نفس المسار. في ظل الحماية الفرنسية، أسست الجمهورية، وسعت حتى لتكون علمانية مستوحية من الثورة الفرنسية والكمالية التركية. سرعان ما فرضت النخبة الفكرية الحديثة نفسها. أما المغرب، الذي كان أيضًا تحت الحماية، فقد عرف تطورًا مختلفًا. تجمدت الدولة المغربية في شكل “المخزن” (والذي يعني مستودع الثروات) و”بلاد السيبة” (السيبة تعني التمرد). ولا تزال المصطلحات السياسية المغربية الحالية مشبعة بهذا التراث. يمثل “المخزن” الأراضي التي تخضع لسلطة الدولة المركزية، بينما تشير “بلاد السيبة” إلى المناطق المتمردة التي تمتد جنوبًا في الأطلس الكبير والأوسط ومنطقة الريف.
مع استقلال الجزائر الثورية، المناهضة للاستعمار، والاشتراكية، والقريبة من المعسكر السوفياتي، شعر النظام المغربي، الذي بالكاد تخلص اسمياً من الحماية الفرنسية، بالتهديد من هذا الجار الوحيد في الشرق. كان من الممكن أن تصبح الجزائر مثالًا خطيرًا للنظام المغربي عبر تقديم نموذج لتغيير شعبي دائمًا ما يكون ممكنًا. لذلك، لجأت الأسرة الحاكمة إلى الخطاب المرتبط بالاستمرارية التاريخية للدولة، ونسبها إلى سلالة النبي محمد ﷺ وعظمتها المفترضة.
مع ذلك، ولأن الخطاب لا يكفي وحده، كان من الضروري إقامة تحالف مع الغرب لموازنة ثقل الجزائر. على الرغم من هذه الاستراتيجية، ظل المغرب بلدًا فقيرًا ومكتظًا بالسكان مقارنة بموارده الطبيعية. كان إستعمار الصحراء الغربية يُعتقد أنه سيمنحه عمقًا استراتيجيًا، ويطيل واجهته البحرية بشكل كبير، ويعزز مكانته كمنتج للمواد الخام والثروات البحرية، مما يثبت استقرار نظامه. ولكن رد الجزائر، المتمسك بميثاق الأمم المتحدة، والمتخوف بشكل خاص من التوسع المغربي منذ الهجوم العسكري المفاجئ عند فجر الاستقلال، كان إشكاليًا، مما وضع البلدين على مسارات مختلفة.
في كل حرب، سواء كانت باردة أو ساخنة، يعتمد المتحاربون على ركيزتين: الأولى عسكرية، والثانية أيديولوجية. الأسلحة تردع أو تدمر العدو، أما الأفكار فتعبئ الشعب ليقبل التضحيات المطلوبة. ولكن فن الحرب يشمل أيضًا إضعاف أو تدمير هاتين الركيزتين لدى العدو، أي أسلحته وروحه المعنوية أو النفسية.
بالنظر إلى أفكار كارل شميت، يسعى المغرب إلى تعزيز أمته عن طريق شيطنة جاره، مما يؤدي إلى إثارة عداء الجزائريين؛ وهو عداء مفيد لاستغلاله في تعبئة الرأي العام حول القصر الملكي.
ومع ذلك، وجد النظام المغربي نفسه في موقف حرج، بين الحاجة إلى التحالف مع الغرب لضمان الأمن العسكري والدبلوماسي، وبين المخاطر التي قد تشكلها هذه الاستراتيجية كدعوة محتملة لعودة “بلاد السيبة”، بالنظر إلى التحديات الداخلية، وأيضًا بسبب التوجه الاستراتيجي المناقض للطبيعة فيما يتعلق بالاختيارات الصهيونية. لذلك كان من الضروري تضخيم صورة المغرب كقوة رادعة للجزائر.
المطالبات الإقليمية بجزء كبير من غرب الجزائر تغزو الخطابات السياسية وشبكات التواصل الاجتماعي. أصبحت الرغبة في الاستحواذ على جميع القيم الثقافية التراثية للمغرب الكبير هاجسًا. حتى التسمية نفسها للمغاربة باللغة العربية تحولت بشكل دقيق من “مروكي” (أصلها من مراكشي أي من مراكش) إلى “مغربي”؛ مما يسمح بانجراف لغوي يمكّن المغرب من الاستحواذ تدريجيًا على “المغاربية” وبالتالي المغرب الكبير بأكمله. فالمطبخ، والحلويات، والملابس، والموسيقى، والهندسة المعمارية، والفسيفساء، وكل ما يخص المغرب الكبير أو بشكل خاص المناطق الجزائرية، يُدّعى أنه ينتمي إلى المغرب!
والأكثر خبثًا هو أن المثقفين المغاربة، بالتعاون مع اليمين الفرنسي الاستعماري والثأري ومع اللوبي الفرنسي الصهيوني، يكررون بلا كلل أن الجزائر ليس لها تاريخ، ولم تكن دولة قبل الاستعمار، وبالتأكيد ليست أمة. ويزعمون أنها كانت فقط نتيجة إنشاء فرنسي، وأنها استفادت بشكل غير عادل من تقسيم إقليمي منحها أراضٍ مغربية. حتى اسم “الجزائر” يُدعى أنه اختراع فرنسي.
الهدف بالطبع هو إضعاف الشعور الوطني للجزائريين، وزعزعة تماسكهم الداخلي، وتعريضهم للشكوك، وفي النهاية نزع الشرعية عن الدولة الجزائرية نفسها، لجعلها تخضع وتقبل النظام الليبرالي وتوسع جارتها.
بغض النظر عن تطور العلاقات بين الجارين في المغرب الكبير، من الواضح أن الشقاق يزداد حدة. إن المغرب الكبير المنقسم بسبب قادته يصبح مرة أخرى، كما كان في تاريخه القديم، فريسة سهلة لطموحات الإمبراطوريات المتعددة.
سفيان جيلالي